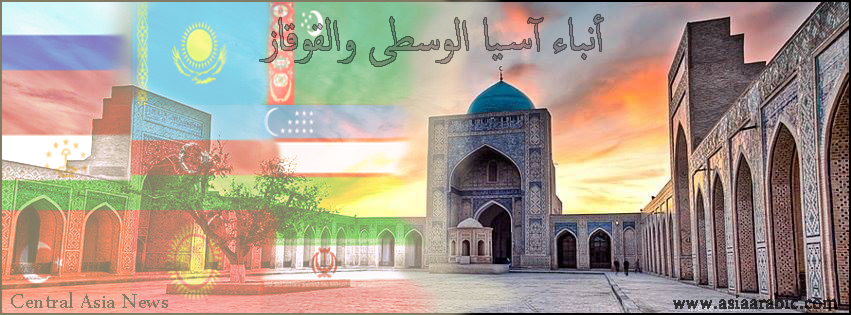- «طاقة ونقل ومواد خام: شراكة أوروبية–آسيوية ترسم مسار المستقبل»
- ترمب يؤكد أهمية آسيا الوسطى ويعزز الشراكة مع دولها الخمس
- الرئيس الإيراني: زيارة كازاخستان وتركمانستان عززت التعاون الإقليمي
- أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا
- العراق يطالب إيران بتسهيل مرور الغاز من تركمانستان
- قاسم جومارت توكاييف: تعزيز السيادة والاقتصاد من أولويات كازاخستان
- كوريا الجنوبية تخصص 3 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في آسيا الوسطى
- شينجيانغ تطلق خط شحن سككي جديد لدعم التجارة مع آسيا الوسطى
- طاجيكستان والكويت تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي وتأسيس صندوق استثماري مشترك
- قرغيزستان تفتح أبوابها للسياح الصينيين دون تأشيرة: خطوة لتعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي
- أذربيجان وقرغيزستان تعززان الشراكة الدفاعية بتوقيع خطة التعاون العسكري لعام 2025
- دعوات إلى إحلال السلام ووقف الحروب في قمة بريكس في روسيا
- العراق يعزز قدراته الكهربائية باتفاقية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان
- التوجه التركي الجديد: إعادة تسمية “آسيا الوسطى” بـ”تركستان” وأبعاده الاستراتيجية
- أذربيجان تشارك كضيف في اجتماع وزراء الطاقة لدول آسيا الوسطى في طشقند
أطراف روسيا الجنوبية الشرقية مهددة بمطالب انفصال قد لا يتحمّلها المركز

جورجيا
سعاد الوحيدي
في الوقت الذي أقام فيه قرار رئيس حكومة كاتالونيا كارليس بيغديمونت (الخارج عن القانون حالياً) بالاستقلال عن إسبانيا، الأرض ولم يقعدها بعد. لم يلتفت العالم لصيرورة مشابهة تمت على الطرف الآخر من الأرض، عندما انتخب الزعيم فلاديسلاف اردزينبا «رئيساً» لأبخازيا في اقتراع وقفت ضده الأمم المتحدة واعتبرته «غير قانوني». وكيف تأكد في سياق دولي مؤيد استقلال كوسوفو عن يوغوسلافيا، مبلوراً دولة وطنية مُضافة على مساحة القارة. بينما تعثر حتى السحق مشروع استقلال الشيشان، أو أدجاريا. الأمر الذي يفرض سؤالاً جوهرياً في هذا السياق: من يقف وراء آليات الرفض والقبول لتصنيف الدول الممكنة والدول المستحيلة؟ وأي معنى للدولة الوطنية في هذه السياقات التي قبلت خلال نهايات القرن الماضي بولادة دولة أندورا المتواضعة الحجم على الحدود الفرنسية الإسبانية؟ رافضة للباسك أو الكاتلان تحقق دولتهم الوطنية على رغم توفر أكثر من معيار يتجذران به وطنياً على مساحة الجغرافيا والعرق واللغة والتاريخ؟
لا إجابة موضوعية عن أي من هذه الأسئلة. وسيكون على المراقب الاكتفاء بالبحث خلف السطور المعلنة أو الخفية. غير أن ما يمكن التأكد منه في هذا الصدد، أنه كان يصعب حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، الحديث عن دولة وطنية أوروبية (أو غير أوروبية بالمعنى المعاصر للمفهوم) نهائية الاستقرار. حيث كانت الحدود السياسية على رقعة العالم، تتبدل أحياناً رأساً على عقب بين عشية الحرب الأولى وضحى الثانية. أو مساء المعاهدة الدولية الأولى وصباح الثانية، وذلك بالقياس إلى استحالة ترسيم حدود نقية، خالية من أي اختلاط للأعراق أو تضارب للمصالح على رقعة بذاتها. فتشابك حراك البشر على الأرض يجعل من المشهد الجيوسياسي للعالم، أشبه بفسيفساء متداخلة. يهدد الفصل بين مكوناتها بقلب موازين الوجود البشري بأسره.
وعلى رغم أن الخيارات الأيديولوجية، التي قدمت السياسة على التاريخ، أو الأيديولوجيا على الوطنية، قد شهدت ولادة «دول وطنية كبرى» في أوروبا مع نهاية الحرب العالمية الثانية (عبر تحالفات معقدة ومتصارعة). إلا أن الأحداث الأخيرة كشفت أنها بدورها ليست نهائية، خصوصاً أن هذه التحالفات ذاتها كانت شطرت أوروبا في الوقت ذاته، إلى معسكرين متخاصمين ما فتئ كل منهما يتربص بجدلية استقرار الآخر. وكان على هذه القارة أن تنتظر سقوط جدار برلين؛ الذي شكل موجة جديدة من التغيرات الجيوبولتيكية للمنطقة ما زالت تهز تفاصيلها، لتبدأ التفكير في إمكانية القفز على الخلافات. والالتفات بالأحرى إلى ما يمكن أن يجمع ويدمج، وذلك من خلال الالتفاف حول وحدة المصالح المشتركة.
الاتحاد الأوروبي وإشكالية الدول الوطنية
هكذا، على رغم عصف الحروب التي مزقت أوروبا الحديثة خلال القرن الماضي. نجد أن أوروبا «المعاصرة» قد دخلت باب القرن الحادي والعشرين وهي متحدة. تسير في سبع وعشرين دولة (بعد انضمام رومانيا وبلغاريا) اليد في اليد. وقد اختارت أن تفتح فضاءها الواحدة على الأخرى، بحثاً عن القفز، وفق هذا المعنى، على ما يخفيه مفهوم «الدول الوطنية» الأوروبية من مدلول متعنت، وسحق لأقليات وقوميات وشعوب وأعراق، كان لها أن تقبل بسياسة العرق الأقوى، وسيطرة اللغة السائدة، والانطواء عند رغبات هؤلاء الذين كانوا يملكون زمام الأمور. غير أن هذه التحولات ذاتها، جاءت في واقع الأمر، وهي تحمل في جعبتها إشكالية مُضافة، شديدة التعقيد، وصفها جان- ايف كامو، خبير الهويات الإقليمية والحركات الانفصالية في أوروبا، بأزمة «التخوف من الوقوع في ما يشبه عقيدة عدم المس بالحدود التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية». وارتباط ذلك في نظره بتعزيز نعرة «الحركات التي تسعى إلى إعادة خريطة أوروبا عبر الارتكاز على معايير اثنية ولغوية أو ثقافية». والتي يردّها إلى «عدم تمتّع هيئات الاتحاد الأوروبي بالشرعية الديموقراطية، والزوال التدريجي للحدود، وتوحيد سبل الحياة، وفرض اللغة الإنكليزية لغة مشتركة». الأمر الذي خلق صدمة ارتدادية لا تخدم المعركة السياسية من «أجل أوروبا أكثر اجتماعية وأقل تكنوقراطية، وإنما في اتجاه تعزيز خصوصية الانتماء».
هذه الظاهرة تقترن بالنسبة إليه بـ «غيرة قومية» في مناطق مزدهرة تشتكي من أنها تؤمّن الموارد لمناطق أكثر فقراً و «تريد الاحتفاظ بضرائبها في مناطقها». وهو ما نراه يتجسد الآن في حراك إقليمَيْ لومبارديا والبندقية في إيطاليا، أو حراك كاتالونيا في إسبانيا. الأمر الذي صار ينذر بقوة بإمكان تحقّق بعض التهكنات السياسية «المقلقة»، التي ظهرت نهايات القرن الماضي. والتي كانت تنحو لإعادة ترسيم الخرائط السياسية، سواء بالقياس إلى موازين القوة الاقتصادية، أو بالقياس إلى مقومات العرق والثقافة واللغة.
في هذا الصدد، شهدت نهايات القرن الماضي، تبلور تيارين متعارضين متخاصمين، (من شأنهما العودة للظهور من جديد في هذه الآونة) جهداً للتهديد برسم خرائط مستقبلية جديدة للعالم، ترد التالية منها، في جدلية معقّدة، على سابقتها. ففي الوقت الذي نحت فيه السياسة الأميركية للترويج لمشروع استبدال الحدود السياسية، التي رسمتها فرنسا وبريطانيا أعقاب الحرب العالمية مباشرة، دون تروٍّ كاف، (خصوصاً أنهما على رغم خروجهما منتصرتين، كانتا منهكتين من الحرب). بحدود أخرى يُستند في ترسيمها، وبالدرجة الأولى، إلى مقومات «العرق» والثقافة واللغة.
هذه التي سيكون من شأنها على سبيل المثال، أن تأخذ في الاعتبار مطالب الأكراد في دولة وطنية جامعة على رقعة الجغرافيا التاريخية لهذا العرق، الممتدة بين إيران وتركيا والعراق وسورية. (السيناريو الذي يقلق اليوم استقرار الشرق الأوسط بكامله). أو الوقوف مع استقلال كوسوفو تمهيداً لالتحاقها بألبانيا، وفق تكامل العرق والدين واللغة بين البلدين. وذلك على الرغم من أن توظيف هذا المنهج بالذات على أميركا ذاتها، «الدولة» التي حرصت على اختزال التاريخ في حدود الواقع، (حتى لا يرتقي البحث إلى مطلع نشأتها، المستند إلى أبشع أشكال الإبادة العنصرية)، سيجعل من كامل حدودها السياسية والجغرافية والتاريخية، رسماً وهمياً ينهض على غير أساس.
في المقابل نجد أن قراءة روسيا للسيناريو الأميركي، تقصره على النية في توفير موطئ قدم للقواعد الأميركية عبر العالم؛ بكل ما يمثل ذلك من تخلخل في موازين القوى لمصلحة قطب واحد مسيطر. واتجهت للتهديد بخلق «دول وطنية» أخرى في أراضٍ مواجهة. ودعم أقليات عرقية تسعى بدورها للانفصال عن دول، ليست بالضرورة وطناً لهذه الأقليات. وذلك على رغم أن تاريخ روسيا يستند إلى تفاصيل مفزعة عن سحق وترحيل وإبادة الأقليات العرقية على أرضها.
السيناريوات المحتملة لجورجيا وجمهورياتها الأخرى
لن يسمح المقام هنا بتتبع تفاصيل الاضطهاد الإثني الذي مارسه الروس، ضد أعراق كثيرة عبر تاريخهم. لكننا سنتوقف أمام بعض التحولات السياسية على خريطة العالم، ذات العلاقة المباشرة مع روسيا. وفي إطار جغرافية «جورجيا» بالتحديد، بلاد ستالين، الذي كان قد ترك بصمات غائرة العمق في هذا الصدد. جورجيا التي انفصلت نهايات القرن الماضي كدولة وطنية مستقلة عن الاتحاد السوفياتي، والتي صارت روسيا تنظر إليها اليوم باعتبارها دمية في يد الغرب الإمبريالي. وذلك بما يسمح بتصور صيرورة تحول (وتعدد) الحدود السياسية الجديدة للمنطقة، وفق تداعيات التصور الأميركي، والرد الروسي المواجه. وبما يسمح باستشراف ما يحمله التهديد الروسي، من أعاصير «جيوبوليتيكية» من شأنها أن تقف على رأس العالم وخرائطه السياسية، وتؤسس في هذا السياق لإعادة هيكلة جذرية لطبيعة وعدد الدول الوطنية التي ستشهد ولادتها المنطقة.
استقلال أوسيتيا الجنوبية
إذا ما أشعل استقلال كوسوفو مخاوف الأوروبيين بشأن مشروع ألبانيا «المسلمة» الكبرى، بكل ما يحمل ذلك من زعزعة غير هينة لخريطة أوروبا، وموازين استراتيجياتها. فإن استقلال أوسيتيا الجنوبية، الذي نال الاعتراف الفوري من روسيا، لا يُعد أقل تأثيراً في هذا الاتجاه. فمن شأن هذه الخطوة كما سنرى، أن تقود وفق السيناريو الأميركي، إلى تداعيات كبرى لن تنتهي عند حدود هذه الدولة الوليدة.
ذلك أن شعب أوسيتيا على رغم انتمائه عرقياً وتاريخياً ولغوياً إلى وطن وتاريخ خاصين وله لغة متميزة هي الأوسيتية، نجده اليوم مُقسّماً في سياق تحولات سياسية وتاريخية مختلفة (كان آخرها تفكك الاتحاد السوفياتي)، إلى قسمين/ أو إلى بلدين. الأول تضمه جمهورية أوسيتيا الشمالية التي تتمتع في نطاق الفيديرالية الروسية بحكم ذاتي. والثاني في جنوب أوسيتيا وهو الذي أخذ يظهر للسطح من خلال التهديد الروسي من جهة، ومن خلال إعلان هذه الجمهورية عن استقلالها الوطني عن جورجيا. (كانت أوسيتيا تتمتع بالحكم الذاتي في إطار الدولة الجورجية، قبل أن تنزل مرتبتها لمجرد مقاطعة في تعديل دستوري بهدف تحجيم فكرة انفصالها)، الأمر الذي قاد إلى حراك مسلح كبير ضد جورجيا، وإعلان الاستقلال من طرف واحد (والذي حظي باعتراف روسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وتاورو وتوفالو).
وبالتالي سيسمح هذا التحقق الجزئي للدولة الوطنية في أوسيتيا الجنوبية، في سياق التصورات «الاستشرافية» لمستقبل القارة، بتصور إمكان قيام «دولة اتحادية» جديدة على أساس العرق واللغة والثقافة، من شأنها أن تجمع بين شطري بلاد الأوسيتيين. على أن إشكالية أخرى موصولة بمقاربة العرق، ستبرز بقوة أمام هذا التصور. فإن الجغرافيا الحالية لشمال أوسيتيا تضم بعضاً من أراضي الأنغوش المسلمين، كانت قد اقتُطعت عنوة من أرضهم الأم. ففي عهد ستالين تمت معاقبة شعوب في القوقاز بالترحيل الجماعي عن أوطانها، بتهمة تحالفها مع العدو النازي، وتقاعسها عن نجدة الروس في حربهم ضد هتلر. (على رغم أن النداء الذي وجهه ستالين لشعبه، كان قومياً صرفاً. دعا فيه الأمة الروسية للذود عن ترابها الوطني ضد المحتل الألماني. وهو ما لم يسمح في حينه للأقليات العرقية الأخرى في الاتحاد السوفياتي، بفهم هذه الحرب إلا كواجب جهوي ضروري للدفاع عن الروس). حيث تم إلقاء شعب الكراتشي (تشرين الثاني/ نوفمبر 1943) والكلموك (كانون الأول/ ديسمبر 1943) والشيشان والانغوش (شباط/ فبراير 1944) والبلغار (آذار/ مارس 1944) وتتار القرم (أيار/ مايو 1944)، في صحارى كازخستان (أو صحارى آسيا الوسطى)، بعيداً من العالم، ومن تاريخهم وأوطانهم ولغاتهم، حيث كانوا يتساقطون من الجوع والبرد والقهر.
في هذا السياق، قام ستالين بمنح بعض من أراضي الأنغوش التي أصبحت خالية إلى أوسيتيا المجاورة. وبعد عودة هذه الشعوب المغضوب عليها لأوطانها مع قانون العفو الذي صدر عام 1956، لم يتم إرجاع هذا الطرف الأنغوشي لأنغوشيا. لكن الأنغوش الذين كانوا يقطنون تلك المنطقة عادوا إلى ديارهم. غير أنهم صاروا تابعين لجمهورية أوسيتيا ذات الحكم الذاتي. وكأن قدر هذا الجزء من الشعب الأنغوشي لن يتوقف عند هذا الحد، حيث أن روسيا ستنهض لمساعدة أوسيتيا الشمالية للتخلص من هؤلاء الأنغوش. وذلك إثر مصادمات عرقية واسعة تمت بين هذين العرقين، على رغم وجود أغلبية من المسلمين الأوسيت في أوسيتيا الشمالية. وقامت موسكو بترحيل كافة الأنغوش في تلك المنطقة عن أراضيهم التاريخية نحو أنغوشيا المجاورة.
هكذا وفق التصور الجديد لمجريات الجغرافيا القومية، يجب أن تجمع دولة وطنية أوسع، بين أوسيتيا الشمالية وأوسيتيا الجنوبية. بمعنى أن يُقتطع في هذا السياق جزء له أهميته من الفيديرالية الروسية لمصلحة الدولة القومية الجديدة. وهو الأمر الذي يجب أن يصاحبه جغرافياً، اقتطاع الجزء الأنغوشي الأصلي الذي تم ترحيل الأنغوش عنه، وإعادته إلى الوطن الأم، أي إلى جمهورية أنغوشيا الجارة. السيناريو الذي لن تنظر إليه موسكو، وبكل تأكيد، بعين الرضا.
جمهوريات بلاد «جورجيا» الأخرى ومطالب الانفصال
غير جمهورية أوسيتيا الجنوبية، تضم جمهورية جورجيا جمهوريتين أخريين بأغلبية مسلمة، تتمتعان بالاستقلال الذاتي. وهما جمهورية أدجاريا، أو بلاد الآجاريين، وجمهورية أبخازيا أو بلاد الأبخازيين. وإذا ما تكرر تصدّر أخبار أبخازيا الصحف وأجهزة الإعلام العالمية، وفق انتفاضاتها المستمرة المطالبة بالاستقلال من جهة، والتهديد الروسي في شأنها من جهة أخرى. إلا أن أدجاريا– التي لا نرى موضوعها يشد أنظار العالم- لا تقل عنها أهمية استراتيجية.
كما أن تاريخها لا يقل عصفاً عن غيرها من الجمهوريات المسلمة في المنطقة. فإن ستالين في عقابه لشعوب القوقاز؛ لم يكتف بتشريد الشعوب المسلمة المُتهمة بالتحالف مع الألمان ضد السوفيات. فثمة شعوب أخرى في أدجاريا، جنوب جورجيا، والتي لم يكن لها أي اتصال مع الألمان، تعرّضت للعقاب ذاته. أما الأسباب التي دفعت ستالين لذلك فنجدها في حقيقة الأمر، في قلب التاريخ.
فمع وصول الفتح العثماني في القرن السادس عشر إلى جنوب جورجيا، انتشر الإسلام بين ثلاثة أعراق رئيسية كانت تسكن تلك المنطقة. وهم اللاز أو اللازجيون ولهم لغتهم الخاصة هي اللأزيه، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم في مناطقهم الخاصة في شمال تركيا. والجورجيون ولهم لغتهم التاريخية التي هي الجورجية، والأجار الذين يتحدثون الأجارية. من بين هذه الأعراق الثلاثة نجد أن جورجيي مناطق اكلتسكي ومسقيط، صاحب اعتناقهم الدين الإسلامي (هم اليوم من الشيعة)، تحول تدريجي عن لغتهم الأم، وتبنّي اللغة التركية.
في القرن التاسع عشر ستضع روسيا قبضتها على المنطقة، وتُدخل هذه الشعوب المسلمة عهداً آخر، سيستمر حتى التوقيع على اتفاقية كارس عام 1921. حيث سيتم بناءً على هذه الاتفاقية إلحاق طرف من هذه المنطقة بتركيا، بما يدخل جزءاً من هذه الأعراق في تركيبة الدولة التركية الحديثة. بينما عادت إلى جورجيا في داخل منظومة الاتحاد السوفياتي السابق بقية بلاد الأدجار حول باتوم، وكذلك شمال بلاد ميسقط حول اكخالتيكه. هذه التي ستتمتع بناء على اتفاقية كارس ذاتها، بحكم ذاتي في إطار جمهورية أدجاريا التي تم إعلانها عام 1922، والتي ما زالت قائمة حتى الساعة. (حاولت أدجاريا الاستقلال عن جورجيا عام 2004 بقيادة أسلان أباشيدزه، وتم سحق المحاولة بالحديد والنار من طرف تبليسي).
في 15 تشرين الثاني عام 1944 قام ستالين بترحيل جورجيي مناطق اكلتسكي ومسقيط الذين صاروا يتحدثون التركية نحو اوزبكستان، مبرراً بأن السلطة السوفياتية أرادت تجنّب أي احتكاك بين الجورجيين المسلمين وتركيا. كما تم ترحيل كل اللأز وأكراد جنوب جورجيا (وأغلبهم من الإيزيديين)، لسبب عرقي لا غير. فإن ستالين وهو من أصل جورجي أراد تطهير مسقط رأسه من كل عرق غريب. هؤلاء بالذات (وكأن قدرهم أن يُصبغ بالوجع الأبدي، وقد تشردوا مراراً عبر الأرض)، لم يتمتعوا بالعفو الذي لحق بالشعوب المعاقبة عام1956. ولم يسمح لهم بالعودة إلى جورجيا، باستثناء قلة من المسقطيين الذين تمكنوا بجهودهم الخاصة من العودة في الفترة الأخيرة.
بالقياس إلى هذه الحقائق، فإن استقلال أو انفصال جمهورية أدجاريا عن جورجيا، سيولد وفق منطق العرق والثقافة واللغة، الحاجة لأكثر من خريطة. من شأنها أن تسمح لكل عرق، بحق الانتماء الجغرافي والسياسي و «التاريخي» لأمة قوية جديدة تأخذ مكانها على سطح الأرض. الحقيقة التي تجعلنا أمام دولة للأز بين جورجيا وتركيا على بحر قزوين. ودولة للأجاريين حول باتوم. وعودة الاكلتسكيين والمسقيطيين المشردين في أوزبكستان إلى جورجيا، على رغم أنهم الوحيدون من شعب المنطقة من يتحدث التركية. ثم ترحيل الأكراد الإيزيديين (المتحدثين بالكردية) نحو كردستان محل النزاع العالمي اليوم.
أبخازيا أو بلاد الأباظة المسلمة
الدولة الأخرى التي سترسم العرقية حدودها وفق هذه التوجّهات الجديدة، هي جمهورية أبخازيا الواقعة على الساحل الغربي من البحر الأسود، ذات الاستراتيجية النوعية وفق هذا الموقع بالذات. والتي كانت قد تمتعت منذ عام 1921 باستقلال نسبي في إطار جمهورية (بلاد الأباظة المسلمة) ذات الحكم الذاتي داخل الاتحاد السوفياتي وحتى عام 1931 عندما أمر ستالين بضم أبخازيا (المسلمة) إلى جورجيا (المسيحية)، كجمهورية ذات حكم ذاتي تابعة لجورجيا.
بعد تفتت الاتحاد السوفياتي، وجدت أبخازيا نفسها ملحقة بدولة وطنية انفصلت هي بنفسها عن التركيبة السياسية السابقة، ففضلت إعلان استقلالها بدورها. إلا أن جورجيا ردّت على الفور على قرار سوخومي بإرسال فيالق مدججة من الجيش الجورجي سحقت المحاولة، واحتلت الجمهورية بالكامل.
هذا الغزو المسلح، حوّل العلاقة بين سوخومي وتبليسي، إلى علاقة غزو واحتلال ومقاومة. كان هدفها من الطرف الجورجي سحق الأمة الأبخازية، وفق تعبير وزير خارجية جورجيا في ذاك الوقت، للتلفزيون الرسمي، إذ أكد أنه «مستعد للتضحية بـ100 ألف جورجي لقتل 100 ألف مسلم أبخازي، وترك الأمة الأبخازية المسلمة بلا ذرية ولا هوية!».
على أن الشعب الأبخازي قابل هذا الغزو بمقاومة واسعة، (صاحبها ترحيل تعسفي للجورجيين، ومجازر واسعة صنّفت في حينه بجرائم تطهير عرقي). وانتخب في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 1999 الزعيم فلاديسلاف اردزينبا رئيساً لأبخازيا في اقتراع اعتبرته الأمم المتحدة «غير قانوني». (حظي باعتراف روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو). الحراك الذي أجبر الجيش الجورجي على مغادرة الجمهورية في أيلول (سبتمبر) 1992، على النحو الذي استعادت معه جمهورية أبخازيا حدودها. وأصبحت أقرب الكيانات السياسية في المنطقة نضجاً لإعلان استقلال قومي يستمد مشروعيته من عراقة تاريخ هذه الأمة على ضفاف البحر الأسود.
مستقبل الدول العرقية على مساحة الجغرافيا الروسية
سيناريو تبليسي مع سوخومي الذي ساندته روسيا، يتكرر بحذافيره داخل الفيديرالية الروسية نفسها.
وعلى رغم أن المجال لا يتسع هنا لتفصيل ذلك، غير أن واجب المقارنة يدعونا لتوضيح رفض روسيا مطالب الأعراق بالاستقلال، والتي لا يقابلها من موسكو غير الحديد والنار. وإذا حصرنا الحديث عن الجمهوريات الإسلامية، أو ذات الأغلبية الإسلامية الكبيرة لا غير، والتي تناضل من أجل استقلالها في مقابل صمت عالمي، نجد على رأس القائمة جمهورية الشيشان، وجمهورية داغستان ونضالهما المشهور.
كما نجد أعراقاً تحتضنها جغرافيا وتاريخ يؤهلانها للتحقّق في إطار دول وطنية تخصها في ذاتها، مثل أنغوشيا، وتتارستان وجمهورية قراتشاي – تشيركيسيا، وجمهورية إديجية أو إديغيا، وجمهورية كاباردينو- بلغار، وجمهورية باشكورتوستان وجمهورية تشاوفاشيا وجمهورية أدمورتيا، وجمهورية موردوفيا وجمهورية ماري، والتي يؤسس كل منها كياناً جمهورياً مستقلاً، على رغم ارتباطه بالحكم المركزي في موسكو. وهي الحرية الجهوية الكبيرة التي حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يلتفّ حولها بعد ثورة الشيشان المشهورة، حيث قلّص من استقلالية الأطراف في انتخاب رؤساء الجمهوريات الذين صاروا يعيّنون مباشرة من العاصمة المركزية، بما يتيح لموسكو فرض أعوانها المخلصين على رأس هذه المناطق.
وعلى رغم أن الإزاحات الديموغرافية ومحاولة الدمج العرقي لشعوب أخرى، وعلى رأسها الروس في مناطق وجود المسلمين في روسيا الفيديرالية. أو نقل المسلمين من أوطانهم إلى مناطق أخرى، بما سبّب اختلال التوازن الديموغرافي. إلا أن المسلمين ما زالوا هم الأقوى في أوطانهم الأصلية، ولا يزالون يملكون الحق والقدرة على الانفصال، وبالتالي خلق مجموعة واسعة من الدول الوطنية الجديدة التي يمكنها أن تغيّر خريطة المنطقة، فهذه الجمهوريات أو الدول القومية التي تتمتع بحق الجغرافيا والتاريخ واللغة والعرق. والتي تحتاج بدورها إلى ترسيم جديد لخرائطها الجيوسياسية، سيكون في مقدورها أن تمزّق تماماً الخريطة الروسية الحالية، خصوصاً أن بعض الجمهوريات الإسلامية مثل تتارستان تقع في قلب الجغرافيا الروسية ذاتها.
الحياة